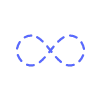عالم ما بعد العولمة .. جائحة كورونا و الحرب على اوكرانيا عجلا بنهاية العولمة او نهاية العالم برمته
يعود نشوء فكرة ومصطلح العولمة في بداياته إلى نهاية القرن السادس عشر، مع الاستعمار الغربي لآسيا وأوروبا والأمريكيتين. وعلى الرغم من تشتت مفهوم العولمة وعدم رسم نهج محددٍ له إلا حديثًا، إلا أنه لطالما عنى تجاوز أي مفهومٍ عن حدوده الجغرافية. وإثر خلافات طويلة على معنى المصطلح، قام المختصون بتقسيم تعريف العولمة لثلاثة تعاريف:
فالأول كان يرى العولمة بوصفها ظاهرةً اقتصادية، والثاني صنّفها على أنها ثورةٌ تكنولوجيةٌ استطاعت ربط العالم، وأما الثالث فنظر للعولمة على أنها ظاهرة اجتماعية.
ورغم نظر العديد من الدول للعولمة على أنها أخذت منحى واحدًا يخدم سياسات القطب الواحد منذ نشأتها، إلا أن معظم الدول انخرط بمفهوم العولمة، خصوصا العولمة الاقتصادية والتكنولوجية، فكانت العولمة أمرًا لا مناص منه لتطوير أي دولة كانت.
و العولمة كأي تيار يحمل عوامل قوته واندفاعه ، فهو يحمل كذلك عوامل ضعفه واندثاره وتلاشيه ... وقد جاءت " العولمة" نتيجة مباشرة لانهيار القطبية الثنائية في العالم ، وانتهاء فترة الحرب الباردة وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها في الساحة كقوة عظمى ، لترسم سياسات جديدة ومذاهب فقهية أكثر تشدداً ، وتطوى بذلك تحت لوائها قوى واهنة، إذ اصبح العالم خلال عصر العولة قرية صغيرة، تتحكم في كل دوله شركات عملاقة متعددة الجنسيات تتحدى الحكومات تحت الضغط الاقتصادي و ذلك بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ، إذ حينها صرّح الرئيس الأميركي الراحل جورج بوش الأب أمام أعضاء الكونغرس في العام 1991، بأن العالم سيشهد نظاماً جديداً. هذا النظام الذي عُرف في ما بعد بـ"العولمة" كسر الحواجز بين الدول، وحوّل الكرة الأرضية إلى "قرية كونية" تتحدّث الإنكليزية . وقد اختلطت المفاهيم عند الشعوب بين تسمية المرحلة بـ"العولمة" أو "الأمركة"، بسبب قيادة الولايات المتحدة للعالم بعد سقوط القطب الروسي.
نشطت في هذه المرحلة الحركات الإرهابية العابرة للحدود، مستغلة الانفلات العالمي وإزالة الحدود ووسائل التواصل عبر الإنترنت، فاتّسعت دائرة تهديداتها لتصل إلى عمق الدول التي تحاربها. وقد نفّذت هذه الجماعات التي أطلق عليها اسم "القاعدة اولا ثم داعش و غيرهما " عملياتها في العمقين الأوروبي والأميركي، وكان من أبرزها هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي أعطى الجيش الأميركي ذريعة الانتشار في أصقاع الأرض.
في النظام العولمي، بات كلّ شيء منطقياً ومقبولاً ما دام غربياً، وكلّ من يخالف الغرب أو يعارض سياساته يُعدّ إرهابياً. في هذا النظام، كانت الصّين تسعى لتطوير اقتصادها، وتعمل للدخول في الاقتصاد العالمي، وكان الدب الروسي ما زال نائماً ومصدوماً بسقوط نظامه، كما دخلت الشركات العملاقة أسواق العالم التجارية، محققةً أرقاماً خياليةً على حساب الشعوب ذات الأغلبية الفقيرة.
تسارعت أحداث، وفرضت تغيرات واقعها الجديد على النظام العالمي، ليعتبر البعض أنَّ القرن الأميركي بات يحتضر، وباتت الدول تعمل على توزيع إرثه، على غرار ما حصل مع السّلطنة العثمانية (الرجل المريض) بعد الحرب العالمية الأولى. لهذا، يتبادر إلى ذهن المحللين التساؤل التالي: من سيقود العالم في المرحلة المقبلة التي تعرف بـ"ما بعد العولمة"؟ وهل سيجدد الأميركي قرناً آخر من الهيمنة، ولكن بأسلحة جديدة وحروب مختلفة؟
ففي العام 2018، تصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقام الرئيس السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات على المنتجات الصينية التي تدخل أسواق أميركا. ولم يكتفِ بذلك، بل فرض عقوبات على عملاق الخلوي الصيني "هواوي" وبعض الشركات الأخرى.
من هنا بدأت النهاية؛ عندما دخل أكبر اقتصادين في العالم الحرب التجارية الطاحنة. ولم تقف الأمور هنا، بل نهض الدب الروسي، حليف التنين الصيني، واختار التوسع العسكري، واستعاد شبه جزيرة القرم، وفرض أمراً مغايراً للسياسة الغربية في سوريا، وأعاق عمل الثورات الملونة في كازاخستان، وها هو يدعم إيران في كسر معادلة التسلح في الشرق الأوسط عبر برنامجها النووي. لقد استطاع الحلف الصيني - الروسي قلب النظام العالمي، وها هو ينقلب إلى نظام متعدد الأقطاب.
في ظلّ المعمعة الدولية وقرع طبول الحرب، تتصدّر العالم حرب من نوع آخر. هذا ما أظهرته ركيزة الخلاف الصيني - الأميركي على من يفرض السيطرة على التكنولوجيا الرقمية الجديدة، وهي الـ"5G"، أي الجيل الخامس لشبكات الخليوي؛ فعالم ما بعد العولمة، كما يبدو، لا يتمحور حول القوى العسكرية، بقدر ما يتمحور السباق الحقيقي فيه بين الشركات حول قيادة مبادرات شبكات الجيل الخامس.
رغم أهمية الترسانة العسكرية في عالم ما بعد العولمة، فإنَّ الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم تبقى رأس الحربة، وهي تأتي في الوقت الذي يتَّجه قطار الاقتصاد العالمي مسرعاً نحو الثورة التكنولوجية وما توفره خدمات الـ"5G" من إمكانيات هائلة في القطاعات كافة، ولا سيما الاتصالات، في ظل تحول الاقتصاد العالمي إلى الاقتصاد الرقمي.
صحيح أنَّ هذه الشبكة ستسمح للأشخاص بتنزيل الأفلام خلال ثوانٍ، وتمنحهم تجربة رائعة عند التجول عبر الإنترنت، ولكنَّ شبكات الجيل الخامس أكثر بكثير من مجرد كونها شبكة إنترنت فائقة السرعة للهواتف النقالة. إنها تكنولوجيا يمكن أن تدعم الجيل التالي من البنى التحتية، وتسهم في تحويل مدن العالم إلى مدن ذكية متصلة، إضافةً إلى تعزيز استخدام السيارات من دون سائق.
ببساطة، إن من يمتلكها سيحدد وجه الهيمنة على النظام العالمي الجديد. ولا تقف الأمور عند هذا الحدّ، فتكنولوجيا الجيل الخامس تمثل ثورة تقنية ستغيّر نمط الحياة البشرية بصورة غير مسبوقة، وما يمكن تسميته "سباق التكنولوجيا" - على وزن سباق التسلح - بدأ بالفعل بين الدول الكبرى.
إنَّ الإنترنت المتنقّل يتطلَّب "معايير" يمكن الاتفاق عليها عالمياً، حتى تتمكَّن الشركات من تصنيع أجهزة الاتصال ونشر التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم. هنا تكمن الحروب القادمة والمختلفة عن تلك التقليدية في عالم ما بعد العولمة، إذ ستكون السيطرة لمن يفرض قراره في عالم التكنولوجيا الرقمية الجديدة.
لهذا، سارعت شركتا "AT&T" و"Verzion" الأميركيتان إلى إطلاق العنان لشبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم الأربعاء 19-1-2022، رغم سلسلة من التحذيرات التي أطلقتها إدارة الطيران الفيدرالي "FAA"، من خلال أكبر شركات الطيران، بأنَّ خطراً حقيقياً قد تسبّبه هذه الشبكات على حركة الملاحة الجوية.
ويتخوَّف الخبراء الأميركيون من احتمالات حدوث تعارض وتداخل بين هذه الخدمة اللاسلكية ونظم تشغيل المروحيات، بما يجعل مقاييس الارتفاع بالرادار، التي تقوم بقياس درجة الارتفاع بالمركبة، غير موثوقة، علماً أنها المقياس الذي يتحتَّم استخدامه بموجب قانون الولايات المتحدة على متن جميع الطائرات التجارية والمدنية.
"الجيل الخامس" هو الحرب القادمة والمختلفة التي افتتحتها الولايات المتحدة في أراضيها، بدلالة واضحة على إصرارها على التحكّم في مفاتيح الحروب الإلكترونية والتكنولوجية القادمة، فالعالم لم يعد عالم العولمة، حيث الانفتاح الدولي تحت سياسة "العصا والجزرة" التي استخدمتها أميركا لتطويع دول العالم. إنه عالم ما بعد العولمة؛ عالم التحدي الأبرز لكسر الطوق الغربي على مفاتيح النظام العالمي. لهذا، يسارع خصوم الولايات المتحدة إلى الدخول في الحرب الرقمية المقبلة.
أخيراً، تسعى الولايات المتحدة لإثارة الصراعات الإقليمية وتأجيجها في الدول التي صنَّفتها إدارة جو بايدن "عدوّاً"، وهي الصين وروسيا، في سبيل شلّ قدراتها التطورية وإشغالها بحروب حدودية، فما يحصل بين الصين والهند، وفي البحر الصيني، وتمرّد تايوان على قرارات بكين، إضافةً إلى تطويق روسيا من أوكرانيا إلى كازاخستان، وغيرها من النقاط الساخنة في آسيا الوسطى وشرقها، دلالة على استراتيجية الولايات المتحدة باعتمادها "سياسة الإلهاء"، بهدف استئثارها بالعالم الرقمي، كي تجعل شركاتها رائدة في العالم الجديد، فهل ستستطيع الولايات المتحدة هذه المرة السير في قرن جديد للسيطرة على العالم؟
وهل يشهد العالم "قمة الديمقراطية"؟ هل المستقبل المحتمل هو الذي ستتنافس فيه المجتمعات المفتوحة ذات الأسواق الحرة مع الدول الاستبدادية على النفوذ في الشئون العالمية في ظل رأسمالية الدولة؟ هل سيشهد العالم انتهاء العولمة، وتزايد الميل نحو عالم متعدد القطبية؟
مثَّلت الأسئلة السابقة محاور اهتمام الخبير الاقتصادي في جامعة برينستون "مايكل سوليفان" في كتابه المعنون: "التسوية: ماذا بعد العولمة؟" الصادر في مايو 2019، والذي يُعرب فيه عن قلقه إزاء عالم يتزايد فيه النمو المنخفض، والديون المرتفعة، ويدعو إلى معاهدة عالمية حول المخاطر، بحيث تلجأ البنوك المركزية فقط إلى تدابير مثل التيسير الكمي في ظل الشروط المتفق عليها.
التعلم من التاريخ
في محاولته للاستفادة من التجارب التاريخية، يستلهم "سوليفان" في كتابه خبرة مجموعة Levellers، التي وصفها بأنها جوهرة خفية من التاريخ البريطاني؛ وهي جماعة تشكلت في منتصف القرن السابع عشر في إنجلترا، وشاركت في النقاشات حول الديمقراطية التي وقعت في جزء من لندن يدعى بوتني. كان إنجازهم الأساسي هو صياغة ما عُرف حينها بـ"اتفاقية الشعب"، التي كانت عبارة عن سلسلة من البيانات التي كانت بمثابة المفاهيم الشعبية الأولى لما قد تبدو عليه الديمقراطية الدستورية.
ويؤكد الكاتب أن هذه الجماعة كانت مثيرة للاهتمام لسببين؛ الأول أن نهجها كان بنَّاء وعمليًّا في سياق الوقت الذي عاشت فيه؛ حيث أوضحت اتفاقية الشعب التي توصلوا إليها ما يريده الناس من أولئك الذين يحكمونهم بطريقة واضحة وملموسة. على سبيل المثال، اقترحوا فرض قيود على مدة المنصب السياسي وتطبيق القوانين المتعلقة بالمديونية بالتساوي على الأغنياء والفقراء.
نهاية العولمة
أكد الكاتب أن هناك أمرين تسبّبا في نهاية العولمة التي نعرفها؛ يتمثل أولهما أولًا في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ونتيجة لذلك أصبح النمو أكثر "تمويلًا"؛ فزادت الديون العامة وبالتبعية زاد النشاط النقدي؛ أي إن البنوك المركزية تضخ الأموال في الاقتصاد عن طريق شراء الأصول كسندات، وفي بعض الحالات كأسهم، للحفاظ على التوسع الدولي.
ويتعلق ثانيها بالآثار الجانبية المُدركة للعولمة التي أضحت أكثر وضوحًا من ذي قبل؛ ومنها عدم المساواة في الثروة، وهيمنة الشركات متعددة الجنسيات، وتشتت سلاسل التوريد العالمية، التي أصبحت جميعها قضايا سياسية في عالم اليوم.
ويستدل "سوليفان" على نهاية العولمة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية وكذلك التمويل الدولي. ففي الاقتصاد -على سبيل المثال- يقول لدينا نمو منخفض الإنتاجية، وهوامش ربح عالية، لكن نمو الأجور منخفض في الولايات المتحدة، وسجلت المديونية أعلى معدلاتها. وكذلك امتلكت البنوك المركزية، التي تعد الآن أقوى من الحكومات، مجمعات هائلة من الأصول، التي اشترتها في محاولة للحفاظ على الآثار الجانبية للأزمة المالية العالمية، مما سيجعل الأسواق المالية أكثر هشاشة، والاقتصادات الهشة أكثر عرضة للخطر.
وفي السياسة، هناك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانتخاب "دونالد ترامب"، وظهور أحزاب سياسية جديدة في أوروبا، معظمها من اليمين المتطرف، بدأت في تعطيل الأحزاب التقليدية والعملية السياسية. كما ارتفع معدل تذبذب الناخبين واللا مبالاة تجاه الأحزاب السياسية الراسخة وانعدام الثقة في السياسة إلى مستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. وعلى نحو خطير، تبدو الديمقراطية كخيار سياسي وكأنها بلغت ذروتها؛ حيث تتجه الآن المزيد من الدول نحو الحكم من قبل رجال أقوياء، ولم تعد البلدان الأخرى تعتبر الديمقراطية جزءًا لا غنى عنه من خارطة طريق التقدم والتنمية.
أما في المجال الجيوسياسي؛ فيتصاعد صعود وسقوط الأمم بوتيرة متسارعة على ما يبدو. إن انتخاب "إيمانويل ماكرون" يمنح فرنسا الآن زعيمًا لديه الأفكار والطاقة لقيادة أوروبا، في وقت تقترب فيه سيطرة "أنجيلا ميركل" على السياسة الأوروبية من نهايتها. وعلى الصعيد الدولي، لم يعد يُنظر إلى الولايات المتحدة كقائد، و زاحمتها دول أخرى في الزعامة الدولية. كما استخدمت سوريا الأسلحة الكيماوية، وهناك دعوات لألمانيا للحصول على أسلحة نووية، وقد أطلقت كوريا الشمالية صواريخ على اليابان كجزء من "طريقها إلى نزع السلاح"، ودخلت الإنترنت ترسانة الحرب في إطار ما يُعرف بالحرب السيبرانية.
ويؤكد "سوليفان" أن أحد العوامل المثيرة للمشاكل هنا هو أنه لا توجد هيئة أو سلطة مركزية لتشكيل العولمة، باستثناء المنتدى الاقتصادي العالمي أو ربما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما اتسمت نهاية العولمة بالاستجابة الضعيفة وغير الحاسمة للأزمة المالية العالمية؛ حيث كانت الاستجابة لخفض تكلفة رأس المال وليس لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة. على هذا النحو، فإن الاقتصاد العالمي سيظل مثقلًا بالديون ويُخفق في الحصول على المال السهل من البنوك المركزية.
عالم ما بعد العولمة
يُشير "سوليفان" في كتابه إلى أن ثمة عالمًا متعدد الأقطاب يتشكل في مرحلة ما بعد العولمة، وسيُهيمن على ذلك العالم ثلاث مناطق كبيرة على الأقل: أمريكا، والاتحاد الأوروبي، وآسيا المتمركزة في الصين، والتي ستتخذ نهجًا مختلفًا للسياسة الاقتصادية والحرية والحرب والتكنولوجيا والمجتمع.
أما الدول الأصغر فلن تكون محصنة ضد هذا الاضطراب، وربما تكون رمزًا للمخاوف والتهديدات الجيوسياسية الجديدة التي تواجهها الدول اليوم. على سبيل المثال، في مايو 2018، أصدر السويديون كتيبًا بعنوان "إذا جاءت الأزمة أو الحرب" يطرحون فيه كيفية الرد في حال نشوب حرب شاملة (هجمات الإنترنت والدعاية وكذلك النزاع العسكري)، والهجمات الإرهابية، وتغير المناخ الشديد، لذا زادت السويد إنفاقها العسكري، وبدأت تجنيد الجنود، وإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق تأهبًا لمخاطر روسيا.
وفي هذا المستقبل الجديد، يؤكد "سوليفان" أنه ستكون هناك طريقتان للتفاعل مع النظام العالمي المقبل. تتمثل الطريقة الأولى في القبول المتزايد للطرق الأقل ديمقراطية في ترتيب المجتمع، سواء في البلدان المتقدمة والنامية، وسيظهر ذلك النظام في بعض البلدان مثل روسيا، أي النظام في مقابل تخفيض الديمقراطية والحقوق، لكن سيظهر صدام مرتبط بذلك النهج يتمثل في رغبة نسبة متزايدة من الناخبين في الحصول على مجتمع أكثر انفتاحًا مع فتح الاقتصادات أيضًا.
أما الطريقة الثانية المحتملة فتتمثل في زيادة التوترات داخل بعض البلدان مثل الصين، حيث يفقد اقتصادها الزخم، في ظل نظام حكم ديكتاتوري حيث سيزداد التوتر بين المجموعات الداعمة للحرية والديمقراطية وتكافؤ الفرص والتعددية الحزبية، والمجموعات المؤيدة لتزايد قبضة الدولة. وفي هذا السيناريو سيكون دور المرأة والأقليات محوريًّا.
ويشير "سوليفان" إلى أن العنصر المثير والصعب للعصر الجديد هو أنه في الوقت الذي يتم فيه إنشاء النماذج السياسية والأحزاب الجديدة، فإن العالم يحتاج إلى اكتشاف إطار جديد للنمو الاقتصادي، كما يحتاج إلى تقليص العديد من المنشطات الصناعية للنمو مثل المديونية وشراء أصول البنك المركزي. وفي هذا العالم الناشئ متعدد الأقطاب، ستصبح العديد من المؤسسات الدولية التي تأسست في القرن العشرين زائدة عن الحاجة مع ظهور تشكيلات جديدة من الأمم وترتيبات مؤسسية جديدة.
آليات المواجهة
يطرح "سوليفان" في كتابه أربع آليات واضحة لمواجهة التحديات الناشئة في عالم ما بعد العولمة، ويمكن إبرازها على النحو التالي:
1- اتفاقية جديدة للشعب: يتم من خلالها تأسيس بيئة سياسية تعزز مسؤولية القادة تجاه الناس، وتجعل الحُكام خاضعين للمساءلة، وتضع أسسًا للتوزيع المتساوي للنتائج الاقتصادية بين الفقراء والأغنياء، وتضع حدًّا للفساد والطغيان. وسيتم التوصل إلى هذه الاتفاقية الجديدة عبر نقاش سياسي أكثر إيجابية وتركيزًا ستقوده أحزاب جديدة ودماء سياسية جديدة، بما سيساعد في إعادة هيكلة المبادئ التي يمكن أن توجه كيفية تعامل المجتمعات والحكومات مع المديونية والتجارة والدبلوماسية والتنمية الاقتصادية.
2- نمو اقتصادي مستقر: إذ ينبغي على البلدان (والشركات أيضًا) التركيز على نمو مستقر عضوي، ينبع من عوامل مثل قاعدة المهارات في سوق العمل، والابتكار والتكنولوجيا، والبنية التحتية غير الملموسة، ونظام القوانين والمؤسسات التي تشكل العمود الفقري للدولة. وفي هذا الإطار تحتاج الحكومات إلى وضع إطار متماسك لإعادة اكتشاف النمو على المدى الطويل، وتزويد السياسيين وأولئك الذين يصوتون لهم بقائمة مفهومة وملموسة لمراجعة السياسات، فضلًا عن تحفيز التنمية البشرية أو البنية التحتية غير الملموسة وهي العوامل التي تطور القدرات البشرية وتسمح بالنمو السهل والفعال لنشاط الأعمال.
3- وضع إطار لتسوية الديون (ويستفاليا جديدة للتمويل): من خلال مؤتمر عالمي يؤدي إلى معاهدة تضع إطارًا عامًّا لتسوية الديون والمخاطر. وعلى الرغم من أن هذا النوع من المؤتمرات لم يسبق له مثيل في التاريخ؛ إلا أنه سيكون علامة واعترافًا بكمية مستويات الديون المتضخمة، كما سيكون جزءًا من وضع القواعد الأولية للعبة من أجل عالم متعدد الأقطاب، على غرار النظام الذي وضعه سلام ويستفاليا التاريخي (1648)، بحيث يكون الهدف الأسمى تحمل المخاطر بدلًا من المشاركة في تقاسم مخاطر الديون، بنفس الطريقة التي شجع بها ويستفاليا الدول على تحمل المخاطر السياسية ومخاطر الهوية.
4- إعادة التموضع في ظل تحالفات سياسية جديدة: في ضوء سيطرة ثلاث قوى كبرى أساسية على عالم ما بعد العولمة (وهي: الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين) ستكافح البلدان متوسطة الحجم (مثل: روسيا، وبريطانيا، وأستراليا، واليابان) لإيجاد مكان لها في العالم الجديد. كما ستضطر الدول التي تفتقر إلى القوة الاقتصادية لتتناسب مع القوة العسكرية للدول الثلاث الكبرى، مثل موسكو، إلى إعادة التفكير في نماذج التنمية الوطنية. وكذلك ستضطر البلدان ذات الإمكانات الاقتصادية الهائلة، مثل الهند، إلى إعادة تشكيل جوانب أخرى من قاعدة قوتها، مثل الجيش الهندي.
من ناحية أخرى، قد تظهر تحالفات جديدة، مثل "الرابطة الهانزية الثانية" للدول الصغيرة المتقدمة مثل الدول الاسكندنافية ودول البلطيق، كما ستظهر مؤسسات القرن العشرين (كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية) على نحو متزايد وسيتسع دورها بشكل أكبر.
إذ من الواضح في كل الأحوال أن العالم سيظل بحاجة إلى المحافظة على التعاون الدولي لتجنب الانهيار الكامل للاقتصاد العالمي، بيد أن هذا التعاون سيتجاوز دون أدنى شك قواعد العولمة المأزومة التي تأسست خلال فترة الأحادية القطبية، من أجل احتواء التحولات التي تحدث على مستوى موازين القوى الجديدة التي يشهدها العالم؛ تحولات بدأت تظهر بشكل تدريجي مع بداية الألفية الجديدة وخطت خطوات عملاقة مع ظهور الأزمتين الصحية والاقتصادية ثم الحب على اكرانيا خلال هذه السنة، التي دفعت الكثير من الدول إلى البحث مجدداً عن الاكتفاء الذاتي والسعي إلى إعادة الكثير من الصناعات التحويلية التي جرى نقلها سابقاً إلى آسيا من دولها الأصلية، وذلك في سياق خطة تهدف إلى التحكم مستقبلاً في مسار العولمة وصولاً إلى تشكيل عولمة مغايرة بناء على قواعد جديدة.
وفي مقابل كل ما يقال عن مظاهر الانتقال نحو مرحلة جديدة في العلاقات الدولية تتجاوز العولمة المعتلة، فإن هناك أسئلة كثيرة ما زالت تُطرح بشأن قدرة النظام الدولي على التخلي عن اقتصاد ليبرالي مرتبط بعولمة مفتوحة تقودها شركات متعددة الجنسيات تتجاوز مصالحها سيادة الدول القومية، بخاصة أن هذه الشركات خلقت أوضاعاً اقتصادية وسياسية من الصعوبة بمكان تغييرها. وهي وضعيات أضحت فيها آليات السوق العابرة للحدود هي المتحكمة في سياسات الدول الصناعية، وبالتالي هل سيكون من اليسير بالنسبة للحكومات إبطال كل مفاعيل العولمة وإعادة كل النسيج الصناعي من آسيا إلى أوروبا وأمريكا؟ وهل ستكون الأزمة الصحية العالمية و بعدها الحرب الروسية الاكرانية كافية للانتقال إلى ما بعد العولمة ولاستعادة الدول القومية لسيادتها على ثرواتها الاقتصادية؟ وهل سيكتفي هذا الانتقال بالتركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن الصحي والغذائي أم أنه سيطال قطاعات أخرى كالتقنية التي تتجاوز من حيث خصوصياتها الإنتاجية قدرات الدول القومية؟
تقودنا مثل هذه الأسئلة إلى التساؤل أيضاً عن مدى قدرة الدول القومية، خاصة في أوروبا وآسيا، على إعادة بناء علاقاتها مع محيطها الدولي انطلاقاً من معايير جديدة تتجاوز ما جرى تأسيسه حتى الآن منذ نهاية الحرب الباردة، بخاصة أن المواجهة القائمة بين واشنطن من جانب، وبكين وموسكو من جانب آخر، تفرض على باقي الدول تحديد طبيعة خياراتها الاستراتيجية.
إن بداية ما «بعد العولمة» وتجلياتها على الساحة الدولية، تظهر في هذه الحالة من التسارع في التطورات الدولية المتعلقة بما بعد العولمة، ليس فقط بسبب الجائحة التي أعادت للدول القومية أهميتها وجزءاً معتبراً من سيادتها الاقتصادية والصحية، لكن أيضاً بسبب قيام الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب بالتخلي عن قواعد حرية التجارة وفرضها لعقوبات على الصين بعد أن اكتشفت أن العولمة تخدم مصالح بكين أكثر مما تخدم مصالحها.
و كما نعلم أن هذا العالم الكبير أصبح قرية صغيرة بسبب العولمة الشمولية ومنها السياسية على وجه الخصوص، فإن آثار الحرب لن يبقى ضمن الحدود الروسية والأوكرانية، إنما سوف تكون عالمية. وعلى مستوى النظام العالمي لا شك أن تلك الحرب سوف تؤدي إلى زعزعت النظام الأحادي و تنهي العولمة و يتجه العالم بعدها الى نظام جديد متعدد الاقطاب و المحاور و التجمعات و التحالفات. هذا إن لم يتأزم الوضع اكثر في الحرب الدائرة بين روسيا و اكرانيا و تدخلها اروبا و الولايات المتحدة الامريكية الى جانب اكرانيا من جهة و الصين و كوريا الشمالية الى جانب روسيا من جهة اخرى و تستخدم الاسلحة النووية و البيولوجية و الكيماوية و غيرها لتنهي العالم برمته.
تجربة نووية أميركية في صحراء نيفادا
إذ ما تزال الأسلحة النووية أكبر خطر محدق بالأمن العالمي، في الوقت الحالي، فيما تقول الدول القوية عسكريا إنها لن تستخدم هذه الترسانة إلا في حالة الدفاع عن النفس مؤكدة أنها لن تبادر إلى الهجوم.
ومع ذلك، تظهر الإحصاءات العسكرية أن ما يملكه العالم في يومنا هذا من أسلحة نووية كاف لتدمير البشرية على نحو كامل، وفق موقع "بزنس إنسايدر".
وأضاف المصدر أن تسع دول فقط تسيطر على 14 ألفا و200 رأس نووي، وتكفي قنابل روسيا بمفردها لإبادة الحياة على نحو نهائي في كوكب الأرض.
طائرات نووية "تحت الماء".. روسيا ترهب الغرب بالسلاح الفتاك
وينبه الخبراء إلى أن خطورة السلاح النووي لا تنحصر في مسألة الهجوم فقط، إذ ثمة أسئلة مقلقة بشأن اختبارات هذه الأسلحة وطرق تخزينها ودرجة الأمان في المستودعات.
وفي التصنيف الذي أعده موقع "بزنس إنسايدر"، حلت كوريا الشمالية التي تعاني عزلة وعقوبات دولية بسبب برنامجها النووي، في المرتبة التاسعة، ويقدر الخبراء رصيدها بـ60 رأسا نوويا.
في غضون ذلك، حلت إسرائيل في المرتبة الثامنة، من خلال ترسانة نووية تصل إلى 80 رأسا، لكن تل أبيب ما زالت تحيط قدراتها النووية بكثير من التعتيم.
أما الدولة الإسلامية الوحيدة في القائمة فهي باكستان وتملك 150 رأسا نوويا، لتحل بذلك في المركز السادس، بينما جاءت جارتها الهند في المرتبة السابعة بترسانة تصل إلى 140 رأسا نوويا.
وتبوأت بريطانيا المرتبة الخامسة من خلال ترسانة تضم 215 رأسا (120 منشورة و95 في حالة تخزين)، وتقدمت لندن على بكين التي تملك 280 رأسا نوويا وتحل في المرتبة الرابعة.
أما فرنسا، فتبرز في المركز الثالث بترسانة قدرها 300 رأس (290 منشورة و10 مخزنة)، كما أنها الدولة الوحيدة التي تسير حاملة طائرات بوقود نووي إلى جانب الولايات المتحدة.
ونالت الولايات المتحدة المرتبة الثانية في قائمة الدول النووية، عبر ترسانة 6450 رأسا نوويا (1750 صاروخ منشور، و2050 في حالة تخزين، أما الـ2650 رأسا المتبقية فتم سحبها إلى التقاعد).
وحسب تصنيف "بزنس إنسايدر"، تحتل روسيا المركز الأول وتملك 6850 رأسا نوويا (1600 منشورة ، و2750 في حالة تخزين، أما الصواريخ الـ2500 الأخرى فتم التوقف عن اعتمادها ودخلت مرحلة "تقاعد").
ملف العدد من اعداد عزيز زياني
عالم ما بعد العولمة .. جائحة كورونا و الحرب على اوكرانيا عجلا بنهاية العولمة او نهاية العالم برمته